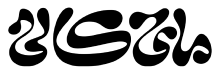بقلم: تازر
العمل الفني: عمر
هذا المقال ملحق بعدد سنة ورا سنة
جرت العادة أن يعتذر لي أصدقائي البيض من أوروبا والولايات المتحدة عَقب كل مرة نلتقي فيها، خشية أن يُتهموا بالعنصرية بسبب مصطلح استعملوه خلال أحاديثنا، كما يسألونني مرارا عما إذا كانت التسميات التي أطلقوها جائزة وغير مهينة!
تراجع هذا التأييد حين وجّه بيترسون رسالة مصورة للمسلمين يعظهم فيها بالكف عن (العداء فيما بينهم والتحلي بالتسامح مع الديانات الأخرى) حيث اتهمته تعليقات على الفيديو بالتعالي وعدم الاطلاع.8

العمل الفني: عمر
الصواب الأخلاقي
يعود هذا التمايز الجذري إلى نشأة الصوابية السياسية ذاتها، ففي ليبيا هي نتاج حساسية الإنسان بمحيطه وساكنيه من الإنسان والجماد بل أنها تتعدى ذلك إلى حساسية عالية تجاه عالم الغيب سواء بالخوف أو الرغبة في التقرب منه.
ويحضر الخوف من الغيبيات كالحسد بقوة في الثقافة المحلية، ومن ذلك يستهجن رفع الأصابع الخمسة خلال الحديث مع أحدهم حتى لا يهان السامع، فالأصابع الخمسة هي علامة الحماية من الحسد. بل يُتجنب في الحديث ذكر الحوت (وهو السمك بالدارجة) وهو من رموز الحماية من الشر والحسد فلا يقال مثلا: “تغذينا اليوم حوت” وإنما يقال: “تغذينا حاشا عيونك” أي حاشاك من أن تصبنا عينك بالحسد وهو من تقديم نفي الإهانة الذي يقابلنا كذلك في العامية المصرية في قولهم عند الدل في الشوارع: “روح لا مؤاخذة، شِمال” أي يسارا ..فالشِمال تعني أيضا الطريق غير السوي المنافي للأدب ولهذا وجب القول مقدما “لا مؤاخذة”، أي حاشاك من الشبهة… كما أنه لا يمكن أن تقول “يعطيك العافية” في المنطقة الممتدة من ليبيا حتى موريتانيا دون أن تلاقي استهجانا أو استغرابا على الأقل، فالعافية في الدارجة تعني النار ولأنها تحرق أي تؤذي، سُميت بعكس ذلك وهي العافية، وحين استقرت العافية اسما للنار أصبحت كلمة العافية بحد ذاتها غير مرغوب فيها!

العمل الفني: عمر
وتنتشر ظاهرة القلب اللغوي كما في هذا السياق عبر ثقافات إفريقية عديدة حيث تحظى تسمية الأشياء والأشخاص بأهمية كبيرة للاعتقاد بدورها -المصيري أحيانا- في جلب الخير ودفع الشر17 وفي الحالة الليبية تصادفنا هذه الظاهرة ضمن آداب الصوابية، ومن أمثلة ذلك أن الأعمى في الدارجة يسمى “ابّصير” أي البصير، والفقير الذي يسأل الناس يسمى “يُوهّب” أي الشخص الذي يهب المال، فصار من العيب أن تطلق على أحدهم “أعمى” أو “فقير” حتى إذا كان كذلك، أما في تونس يوصف الشخص البدين بكلمة “بصحّته” أي الصحيح المعافى حتى إذا لم يكن كذلك!
نقّحت مدرسة التصوف في ليبيا هذه المخاوف وحصرت انشغال الناس بالخوف من الغيب في (تقوى الله) بوصفها القاعدة لإفشاء المودة والمعاملة الحسنة والكلام الطيب وهو ما تشترك فيه مدارس التصوف في شمال إفريقيا لاتصالها وتداخل طرقها، وتعتبر رسائل المصلح الكبير عبد السلام الأسمر لمريديه في مناطق شمال وغرب وشرق إفريقيا نموذجا لارتباط التدين بقبول ومحبة “البار والفاجر” كما جاء في رسالته لتلاميذه في المغرب حيث أضاف على هذه النصيحة الإحسان إلى المسيئ والظالم كما يقول لتلاميذه في طرابلس “اوصيكم ونفسي بتقوى الله…وبلين الجانب لكل بار وفاجر، وبالإحسان لجيرانكم، واصبروا على إذايتهم لكم..ولا تقابلوهم بضد ما فعلوا وأعفوا عنهم ..”. الأسمر الذي عاش في ليبيا خلال القرن السادس عشر الميلادي، يعد علامة فكرية فارقة في الخطاب الديني والإنساني في المنطقة،19 حيث أسهم بشكل رئيسي في تشكيل مدونة الصوابية الأخلاقية فأوجب احترام المقربين كالجيران مرورا بشرائح المجتمع المحلي حتى شمل ضرورة احترام تعددية اللغات والإثنيات الإفريقية المختلفة، فنجده يوصي تلاميذه المهتمين بدراسة اللغة العربية في تمبكتو بدولة مالي الحالية: “ولا ينبغي للنحوي أن يرى نفسه فوق غيره تكبرا..ولا يحل له أن يستهزئ بكلام الغير إذا قارنه اللحن. لأن الجل من الناس برابر وأعاجم..”.20
بيد أن هذا التراث لم يحظ بالدراسة الكافية فظنّ الرافضون في هذه البلدان أن الصوابية السياسية اختراع غربي يسعى لنشر الانحلال الأخلاقي بينما يعتبر مؤيدوها بأنها - بشكلها الغربي - الأداة الأجدى لتعزيز حقوق الإنسان، والواقع أنه ثمة مساحة في التراث الشمال إفريقي لتعزيز “حقوق الإنسان” والقيم الأخلاقية المحلية بدلا من استيراد الجدل الغربي حول الصوابية السياسية، يمكننا أن نجد توازنا معرفيا بين محاولة فهم مجتمعاتنا من الداخل لعلاج مشكلاتها من الثقافة ذاتها، وبين توسيع رقعة الصوابيات المحلية لتشمل كل مستحدث يطرأ عليها من التجارب العالمية.
- Political correctness.
- Nina Degele, “Political Correctness zwischen Gleichheit, Privilegien und Gerechtigkeit,” Außerschulische Bildung, no. 4 (2021).
- Cancelling.
- Cancel culture.
- Paris Will and Odessa S. Hamilton, “Is political correctness holding back progress on diversity, equality, and inclusion?” LSE Business Review, September 6, 2021.
- Martina Thiele, “Political correctness and Cancel Culture – a question of power! The case for a new perspective,” Journalism Research 4, no. 1(2021): 50-57.
- Dorian Lynskey, “How dangerous is Jordan B Peterson, the rightwing professor who ‘hit a hornets’ nest’?” The Guardian, February 7, 2018.
- Jordan Peterson, “Article: Message to Muslims,” July 13, 2022.
- “استطلاع: نصف الليبيين تقريبا يعتبرون التمييز العنصري مشكلة في البلاد,” الوسط; “تونس: الخطاب العنصري للرئيس يُحرّض على موجة عنف ضد الأفارقة السود,” منظمة العفو الدولية.
- Tokenism.
- Woke.
- People of colour.
- Infantilization.
- Identity Reductionism.
- Exotisch.
- تازر، حرب الضمائر: مش راجل!، جيم.
- Rethabile Possa-Mogoera, “A bad name is an omen: Stigmatising names amongst the Basotho,” Literator 41, no.1 (2020): 2; Gladys Udechukwu and Nkoli Nnyigide, “The religious and socio-cultural implication of African names: Igbo naming system as a paradigm,” International Journal of Arts and Humanities, 2016.
- عبداللطيف محمود البرغوثي، التاريخ الليبي القديم من أقدم العصور حتى الفتح الإسلامي، ص 126، مؤسسة تاوالت، 2013.
- أ. العرباوي عمر، الأبعاد الإنسانية في المشروع الإصلاحي للأمام عبد السلام الأسمر، قراءة في مكانة المرأة والشباب كبعد اجتماعي إنساني، أعمال المؤتمر الإصلاحي ـ للعلامة أحمد القطعاني، 2023 ، ص 161.
- رسائل الأسمر عبد السلام بن سليم الإدريسي الحسني إلى مريديه ، جمع وتحقيق ودراسة: مصطفى عمران رابعة، المدار الإسلامي، 2002، ص233.