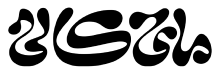J.D Harlock :بقلم
ترجمة: هبة مصطفى
العمل الفني: قضوضة
هذا المقال من عدد الذبذبات
ملحوظة على استخدام كلمة “شيوخ”: في لبنان، تُستخدم هذه الكلمة للإشارة إلى النخبة السياسية وأبنائهم الذكور، أو بعبارة أخرى، هي كلمة ستُطلق يوماً ما على زملائي الذين ذهبت معهم إلى المدرسة
الخطاب السياسي في بيروت معروف بتقلبه، وصخبه، وعدوانيته، ونجده في وجهنا أينما ذهبنا، وهذا متوقع؛ فكما هو الحال مع جميع المنافسات الصبيانية في لبنان، يبدأ كل شيء في فناء المدرسة.
لا يهم نوع المدرسة التي تذهب/ين إليها ولا يهم مكانها، ستجد/ين دائماً الطلاب يسيرون في مجموعات مستعدين للشجار، يهتفون الشعارات السياسية، على أمل أن يلفت هذا انتباه مجموعات من الأحزاب المعارضة لتدخل في عراك معهم، وتسوء الأمور، ثم يندلع الشغب، دون أن يتعلم أحد أي شيء، وبعد أن تجبر إدارة المدرسة الجميع على التصالح والتصافح، يعاود الطلاب الكرّة بحلول الوقت الذي يقرع فيه جرس الفسحة التالية.
من المفارقة أن لبنان معروف أيضاً بتعدديته الدينية التقدمية نسبياً والممثلة في المجالين الاقتصادي والسياسي، ويخصص البرلمان فيها عدداً محدداً من المقاعد لكل طائفة، وبما أن السياسة هنا تنقسم على أسس طائفية، فإن هذا يعني أن كل ديانة من الديانات الرئيسية قد شكلت حزباً لها مع شبكات حصرية تسمح بانتقائية للمقربين منها من “أشباهها” بالانضمام إليها، ومع وجود ثماني عشرة طائفة مختلفة معترف بها في نظامنا السياسي، وأحزاب سياسية متعددة تتظاهر بتمثيلها، فإن نطاق وصول هذه التنظيمات يختلف عما عليه الحال في البلدان الأخرى، ويبدو أن كل شخص تعرفه تربطه صلة ما بالنخبة السياسية بغض النظر عن خلفيته أو خلفيتها، وقد أصبح الحفاظ على هذه الصلات ضرورة إذا ما أراد المرء أن يتعامل مع المنظومة، والنجاة مرهونة بفعل كل ما يلزم لاسترضاء الشيوخ وحاشيتهم.
على الرغم من أن “المستنيرين” بيننا قد فهموا كم كانت مباريات الصياح والعشائرية الطائفية سطحية ومصطنعة، إلا أنها، وللمفارقة، قد أعدتنا للمشهد الصوتي السياسي في العالم الحقيقي؛ فقد عُلّمنا ما هي الخطابات السياسية التي يجب أن نقبلها وممن يجب أن نقبلها
ليس من المستغرب أن تلعب السلطة بعقولهم، وليس ثمة مثال أوضح على ذلك من أبنائهم الذين سيذكّرونك بوجوب امتنانك للفتات الذي يصل إليك منهم والحماية التي يقدمونها لك من أي “آخر” يحلو لهم شيطنته في أي وقت، وبحلول الوقت الذي يبلغ فيه هؤلاء الشيوخ الصغار سن الرشد تصل خطبهم الهجائية الرنانة إلى قمتها، تلك التي يبدأ بها كل نقاش سياسي في جامعاتنا، ومع هذا، بطريقة أو بأخرى، لا زلنا نُفاجأ باندلاع الشاجرات في الحرم الجامعي لدرجة يتعين على سلطات إنفاذ القانون المحلية التدخل، وإن كان هذا ليس مفاجئاً لأي شخص التحق بأي جامعة هنا.
أيام كنت طالباً، كانت إدارات المدارس تدعي أنها تتخذ إجراءات صارمة ضد هذه التصرفات البهلوانية المثيرة للمتاعب خشية اندلاع مشاجرات عامة تشمل المدرسة بأكملها، ومع ذلك، بدا أن أولوياتهم كانت موجهة أكثر نحو استرضاء آباء الطلاب المسؤولين عن هذه المشاجرات، وفي ظل التدخل الضئيل أو المعدوم من جانب الإدارة، كان يُعاد تمثيل المباريات الكلامية الصاخبة لضيوف البرامج الحوارية والوصلات الارتجالية لممثلي الاسكتشات الكوميدية الذين يظهرون على شاشاتنا في الفصول الدراسية؛ فكان الطلاب يقفون على مكاتبهم كما لو كانت منابر ليُطربونا بتقليدهم المحمّل بالشتائم والسباب وآراء آبائهم المشبوهة، وبالكاد كان المعلمون يتقنون تجاهل ما يسمعون كي لا يشركوا رؤسائهم في الأمر.
اضطررت إلى الاستماع إلى هذا كله يومياً، لدرجة أن صمت الشيوخ الصغار أصبح يصم الآذان؛ فقد كانت لحظات الهدوء مجرد وقفات مؤقتة في خطبهم العصماء التي لا تنتهي ضد أي تطورات في المشهد السياسي، وفي العقد الأول من الألفينيات وأوائل العقد الذي تلاه، كان هناك الكثير منها، ولم تكن تمر سوى ساعات قليلة حتى يحدث شيء ما يجعلهم يفجرون تعليقاتهم الساخنة مرة أخرى، ولم يكن هناك ما يمكن فعله لوقف ذلك، وكان صمت الأساتذة والطلاب “من غير النخبة” خانقاً؛ فقد ورثنا رغبة آبائنا وأجدادنا في إبقاء الأمور في طي الكتمان، ونعيق أبناء النخبة، الذي فُرِض علينا بالتهديد والترهيب، لم يسحق المعارضة فحسب، بل نظمنا في هياكل اجتماعية هرمية من اختيارهم، وكانت التحالفات السياسية هي ما يُملي الصداقات، وكان الحلفاء من مختلف الأحزاب يتجمعون في دوائر اجتماعية أغرقت جوقتها المعارضين والمعارضات، وعلى الرغم من أن “المستنيرين” بيننا قد فهموا كم كانت مباريات الصياح والعشائرية الطائفية سطحية ومصطنعة، إلا أنها، وللمفارقة، قد أعدتنا للمشهد الصوتي السياسي في العالم الحقيقي؛ فقد عُلّمنا ما هي الخطابات السياسية التي يجب أن نقبلها وممن يجب أن نقبلها.

العمل الفني: قضوضة
لكن سلوك هؤلاء الشيوخ الصغار ليس مفاجئاً؛ فلأنهم قد وُلدوا في ظل امتيازات علمتهم منذ سن مبكرة ما هو مقبول باعتباره ثقافة سياسية في هذه الدوائر، كانت كلماتهم مشبعة بالقوة والشرعية لم نتمكن من الشعور به تجاه معتقداتنا، فقد ارتبط في أذهان أهالي الطلاب من عائلات الطبقة المتوسطة غير النخبوية تلك التي لم تكن منخرطة في السياسة كل ذلك في أذهانهم بالتهريج الأرعن، أو لم يعبروا عن آرائهم السياسية لأنفسهم خشية أن يضايق أبناؤهم من لا ينبغي مضايقتهم.
بدا الصمت الناتج منطقياً بالنسبة لنا عندما لم نفهم عواقب البقاء صامتين، وهو ما كان بمثابة شكل من أشكال الموافقة الضمنية التي شجعت الشيوخ الناعقين على إعلاء صياحهم العقائدي، وأكسبت خلفياتهم السياسية “المرموقة” أصواتهم ثقلاً، وكانت لهجتهم ونبرة أصواتهم مشبعة بالثقة على نحو لم يمنحها حضوراً وضخامةً فحسب، بل أضفى الشرعية أيضاً على الهراء الذي تم تلقينه لنا.
في المنزل، لم يكن من السهل التحدث عن المشكلة مع عائلتي؛ فقد وجدت صعوبة في التعبير عن ما أجده إشكالي في الأمر؛ فلم أكن مثقفاً سياسياً في ذلك الوقت، ولم أكن على دراية بالديناميكيات الطائفية والاجتماعية الثقافية المحلية والإقليمية التي تقف وراء مكائد النخبة السياسية، ولم تكن لديّ الفصاحة لشرح ما كان يحدث في فصولنا الدراسية وأفنيتنا شرحاً صحيحاً، وبالنسبة لعائلتي، بدا الأمر وكأنه شكل من أشكال اللعب الخشن المعتاد بين المراهقين المشاغبين، وبدا كما لو أن الطلاب الآخرين كانوا يعتقدون أن هذا هو الحال أيضاً، مُصرّين على أن هذا هو شكل الحياة هنا، وما كانت عليه وما ستكون عليه دائماً.
كنت بمفردي، وكان على العديد منا الرد على اتهامات الأجندات الخفية والتجسس الدولي التي كان يلقيها هؤلاء الشيوخ بأريحية على من يختلفون معهم، أو، في حالتي، التعامل مع الازدراء الصامت الذي كانوا يوجهونه إلى من لا يستحقون طاقتهم، وصدقاً لم يكن لدي أي فكرة عما كانوا يصيحون بشأنه – خارج نطاق قضايا مثل البيئة أو مجتمع الميم عين+ ووجدت صعوبة في محاولة فهم المناورات السياسية لهذا الوضع الفوضوي، ناهيك عن مواجهته؛ فلم يكن بوسع المرء التنديد بأكاذيبهم فحسب، بل كان يجب أن تكون لديه الطلاقة اللازمة لمجاراتهم في الحديث.
لأنه إذا لم تصرخ ملء حنجرتك، فقد خسرت الجدال بالفعل.