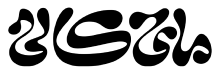بقلم خوخة ماكوير
تصوير: خوخة ماكوير
هذا المقال من عدد عقدة الواوا
تنبيه: يتضمن النص محتوى جنسي ⚠️
يمتدّ شعوري بالحزن على بعد سويعات من استيقاظي إلى حين عثوري من جديد عما قد يلهيني عن آلام البقاء ورغبتي الملحة في الاختفاء. أُطفئ يوم الجمعة ستّاً وثلاثين شمعة وأُرجئ هذا العام عشرات الآلاف من الآمال والأحلام. يقولون: ليست الأعمار سوى أرقام لكن ثقل الأعوام يُربك خطى أقدامي ومجموع الخيبات تُنهك إقدامي على الحياة. والمُراجعات … المُراجعات. والتشبّث بالقشّات ومحاولات النجاة.
سنة واحدة لا تكفي للتعافي والنهوض، ليس من الفيروس -الذي يُخمد بالعقاقير ولا يُطرد- إنما من أثر السقوط الحرّ الذي تَلاه. بل إنّ سنة بأكملها لم تكف للتعرّف على جسدي المُخترق أو “التعايش” مع مُستعمريه الجدد. ‘الإتش-آي-في’ كقرصان أو كحصان طروادة، ضيف أبديّ ثقيل الظلّ، يحلّ مستقدماً معه ضيوفاً أثقل. لعلّ من أخفّها أعراض الاختراق وأعراض الترياق؛ كالإرهاق والبثور وغيرها من الأمور التي تطفو تارة وتارة تغفو. وأمّا أثقلها فهو الشعور المستتر والقارّ بالانكسار والاستنفار. سنةٌ كانت بالكاد تكفي لتقبّل واحتضان الوهن والسيلان اللذان يصاحبان العلاج.
أقتعد المرحاض. أحدّق في طبقات الشحم الثلاث. متراصّة، جاثمة على بطني وعلى ما بقي من رضواني وافتتاني ببنياني. يقول صديقي المتعايش، مجيباً على نحيبي المستمرّ، بأن مضادات الفيروسات القهقرية (الموصوفة لعلاج ‘الإيدز’) هي ما يوقد نهمي. وتعلّق طبيبتي، فخورة بزيادة وزني، بأن انفتاحي على الأكل مؤشّر مبشّر.
خلف كثبان البطن الناتئة، أعتصر هاتفي الذكيّ
بين كفَّي، أجوب به أركان الكوكب الأصفر ‘غريندر’ (Grindr)، أو “حقل الأجسام مبتورة الرأس” كما أصفه. ولمن لا تـ/يعرف غريندر -وقد فاتهـ/ـا الكثير- فهي تطبيقة المواعدة الخاصّة بالمثليين والأكثر رواجاً بينهم. وهي على ما يبدو مورد النيك الأول لمثليي تونس، ومن بعدهم الترانسات أو “الترافستيات” أو “التراف” كما اعتدن القول.
طبقات الشحم الثلاث وحدها كفيلة بالقذف بي خارج أسوار الكوكب الأصفر، أي خارج دوائر الشبق والمتعة والرغبة. فإن لم تكن شحومي وبثوري وترهلاتي حائلاً دون اللذة فخنوثتي، وإن لم تكن الخنوثة فهو الفيروس. ثلاث طبقات من الوصم تتناوب وتتعاضد لتقبر حياتي الجنسيّة بعد أن دقّ الفيروس آخر مسمار بنعشها. جمّدت حياتي الشبقية لعام يزيد، واليوم أخرّ من الإعياء وأقرّ: يُنهكني هذا العُدوان الثلاثي على جسمي ويُربك العلاج الثلاثي جسمي ولا أعلم كيف يزيدني هذا تمسّكاً بالبقاء.
بعد عشرة أيّام على تلقّي خبر الفيروس، أي في 13 نوفمبر 2021، كتبت منشورا عامّا على فيسبوك أستعيد فيه وقع الفاجعة: “غريبة هي طريقة الذهن في التعامل مع الطوارئ ومع البدايات والمفاجآت. أتمشّى في طريق العودة إلى المنزل بعد اكتشافي لإصابتي بالفيروس، إذ يقرّر عقلي مخاطبتي بالإنكليزية قائلاً: لا بأس، it’s just another layer of something. أجبته بلهجتي المحكية: لا يزّي ميبونة، لا يزّي كريوكة، لا يزّي فقيرة، لا يزّي بلا عائلة… زيد séropositive.” (ألا يكفي كوني مأبون[ة]، وخنيث[ة]، وفقيرة وبلا سند… ليضاف إلى ذلك الفيروس).
أُسأل كثيراً عمّا يدفع بي للبوح. ألم أندم لإفصاحي عن إصابتي بالإتش-آي-في؟ وبّختني صديقتي المتعايشة والعابرة جندرياً، بلطف وعطف وخوف: “أخطأتِ خطأ فادحاً! ها قد حكمت على نفسك بالوبال. من سيلتفت لك الآن؟” أما طبيبتي فتؤكّد: “لا تجعلي فيروساً مجهرياً ضئيلاً يغلبك.” تصف طبيبتي الفيروس بالضئيل وهي لا تعي بأن للفيروس هالة تتمطّط.
يتمدّد الفيروس فيتغشّاني فنتوحّد. قد أصبح روّاد غريندر يُلصِقون وجهاً آدمياً مألوفاً على فيروسٍ خفيّ. بعد إعلاني عن تعايشي مع الفيروس، أصبح الفيروس موضوعاً يسود بريدي على غريندر. رسائل تواسي ورسائل تستفسر ورسائل تثور على وجودي على سطح الكوكب الأصفر؛ “كيف تجرئين على التواجد هنا وأنت حاملـ/ـة للفيروس؟”، “لا يفترض بك البقاء هنا”، “أنت خطر” … ينتزع روّاد غريندر الآدميّة عنّي فأُصبِح كفيروس بحجم بشري قد حلّ بينهم.
معايير الكوكب الأصفر حمقاء وصفراء كمعتمريه، لكني لم أيأس من البحث فيه عن ذكرٍ يُعيد اختراقي وتدشين وعائي. تُزرع الأجسام على سطح الأصفر بلا رؤوس، فالجوّ على غريندر مريب وسامّ. أجزاء وأعضاء مبتورة ومحشورة داخل مربعات كمعلبات مرصوفة للبيع بالتفصيل، حيث لا يعدو مجمل كيانك على غريندر سوى كبسة زرّ. عبر الشاشة، أحطّ بإبهامي على صور أجسامٍ وأسامٍ وأوسامٍ تنادي؛ “نيّاك وزبّي كبير”، “مهبول نيك”، “زبّ خشين”، “زبّي هايج”، “23 سنتيمتر”، “رجولي”، “فحل”، “موجب جادّ”، …إلخ. أتوقّف عند اللاطة المفاحيل. أفاوض ذكوراً جامحة لتلوط بي، وأتمنّى لي عودة شبقية ميمونة.
أمقت غريندر بشدّة ولكنّي أعود إليه -مكرها لا بطلا- إذ لا سبيل لي إلى النيك سوى هذا المقيت الأصفر، فأنا لا أحسن المواعدة سوى من وراء حجاب. هذا الحجاب الإلكتروني الذي يستر خجلي ويحمي أوجه الروّاد من خطر التعرية، يفتح أبواب المجازفة بين الأغراب. فخلف المنمنمات المصفوفة والمهارات الموصوفة تتوارى أقدار وأخطار غير معروفة.
كان يوم إصابتي بالفيروس اعتيادياً ومرتبكاً كغيره من الأيام. يومٌ يختزل عشرين عاما من المعيش الجنسيّ الهشّ والمرعوب. فمنذ انخراطي في الجنس في سنّ مبكّر إلى حين توقّفت، لم أذق طعم لذة لم يدنّسها التوجّس والذعر. من أوّل أير مكتنز صافحته، داعبته، لاعبته، لعقته، استطعمته خلف باب موصد … حيث كانت ذائقتي تسترق المُتع من أعين الذئب، وأذاني تسترق السمع من الثقب.
اعتدت اختلاس اللحظات وركوب المجازفات منذ أن وطأت أقدامي أراضي الجنس المحرّم. كنت كمن يعبر حقل ألغام … وظلّت نفس الأقدام مرتعشةً تعافر في مضامير المتعة طوال عقدين.
هل كانت لذة اللواط تستحق عناء الرحلة؟
لم يكن النيك هدفي قط إنما كان مساراً إجبارياً أسلكه لعناق واستنشاق أجسام الذكور. لم أكن أبحث سوى عن دفء الفحول التي تقسو أمام الأعين، وتلين في مخدعي.
في عالم تحكمه الثنائيات، صمدت كذات خنثوية مشطوبة واقتحمت بجسدي المنبوذ حميميّة الفحول وجاهدت لأراني مرغوبة. ربما لم يكن حبّ الذكور يستحق كل هذا السعي. لكن، ها أنا مازلت أسعى وأشقى لأعجِب ولأُرغَب. هذا الشتاء، مازلت أحلم أيضاً بفحل مستعر ألهيه بدُبري لأسترق من لحمه عناقا وأستغرق في شمّه أشواقاً.
أدسّ الشطّافة بدُبري المنكمش فيرتعش. قد أصبح ثقبي خجولاً كسولاً فلم يعتمره قضيب منذ حولٍ وربع. كانت بوابتي السُفلية في أوج عطائها تبتلع أشرس القضبان كثقب أسود.
فيضٌ من ألبان الذكران كانت تدفُق عبر قناتي. أشرد مع ذكرياتي في غبن، ثمّ أستعيد مغامراتي بحنين وفخر، وأعود لأنغمس في تطهير ممري الدودي أو اللوطي، لعلّه يستقبل معتمرين جدد ولعلّي أفتتح مواسم المجد مجدداً.