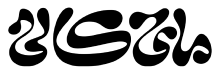بقلم : رباب الرزيني
صور : سارة القنطار
هذا المقال من عدد عقدة الواوا
كم من حضن، ولمسة أو حتى قبلة احتفظت بها أزقة بلداننا الضيقة كأسرار لأصحابها فقط؟ كم من العار والخجل كان يرافق أي اثنين تصدفهما أعين شرطة الأخلاق الاجتماعية ببلداننا السعيدة؟
كنا نتساءل، هل يتوقف هذا الوصم عند تحقيق “حلم الهجرة “إلى بلدان الغرب كما يعتقد جُلّنا؟
أنا وسارة قمنا بإعداد هذا التقرير التصويري بعد أن طرحنا على الطاولة العديد من التفاصيل التي نتشاركها كمهاجرين ومهاجرات في أوروبا.
يمكننا ببساطة أن نعي مدى إشكالية موضوع تفصيلي كهذا لنعالجه، فتحليل موضوع كالتقبيل أو الحميمية في الأماكن العامة قد ينئ بنا ببساطة إلى الوقوع في فخ المقارنة بين ديستوبيا دول الجنوب ويوتوبيا الغرب المتحرر التي نراها في الأفلام والمسلسلات.
عندما سألت سارة عن سبب اهتمامها بهذا الموضوع بالذات كان ردُها أن هذه التحولات التفصيلية التي مررنا بها أثناء مغادرة بلداننا والوصول إلى دول اللجوء هي التي تجعل تجربة الهجرة محورية في تشكيل توجهات الأشخاص وعلاقتهم.ن بذواتهم.ن، أجسادهم.ن والآخرين.
لكي أتعمق في هذا البحث الميداني وفي محاولة مني للابتعاد عن فخ المقارنات ذاك، لجأت “للشخصنة” كما أردت تسميتها، فموضوع حساس كهذا لا يمكن أن يُظهر أهميته إلا عبر قصص المعنيين والمعنيات. ولهذا قمت أولاً بإجراء مقابلة مع سارة القنطار، مصورة هذا التقرير التي تحكي لنا عن رحلتها الشخصية عبر الصور. تجيب سارة في هذا المقتطف من المقابلة عن سؤالنا الأساسي : هل تشكل الهجرة الى الغرب تحوّلا في فهمنا للقبلة ؟
– “لقد تغيرت كثيرًا، عندما أتيت من سوريا كنت خجولة للغاية، كنت لا أزال أشعر بالخوف، أتذكر أنني يوم كنت أودع الشخص الذي كنت أحبه في سوريا لم أستطع تقبيله. كانت شفتانا متقاربتان جداً، أتذكر هذه اللحظة كثيراً، كنت أعلم أنني لن أراه مجدداً، لقد قبلته على خدّه وأدرت رأسي، كان الخوف يغمرني.
عند وصولي الى باريس لم أصب بصدمة ثقافية بل كانت ثورة شخصية، كنت أعي في تلك اللحظة أن خوفي لم يعد مبررًا، بدأت باكتشاف “ألوان جديدة”.
يمكنني القول اليوم أن أغلب صديقاتي في المهجر تعشن تحررًا جسديا معينا لم يكنّ يحظين به من قبل، ليس لأن هذا المجتمع يمثل الحرية المثالية ولكن لأننا كأجانب لسنا تحت المنظار الاجتماعي كما كان الحال ببلداننا. هنا، لا أحد يعرفني فلا تهمني الأحكام.
كنت بحاجة للكثير من الوقت لكي أتخلص من التعليقات السلبية والشعور بالعار عند رؤيتي لقبلة في الشارع، التقبيل هو بداية فعل الحب، إنه يمثله.
القبلة أو الحضن أو اللمسة لفتة بسيطة، لكنها كانت دائمًا من المحرمات بالنسبة لي. أستطيع أن أقول إنني لم أر والديّ يقبلان قط، أتذكر عندما كان مشهد القبلة يظهر على التلفزيون، كان والدي يطفئ التلفاز ونشعر بالخجل الشديد، وأعتقد أنني أشارك هذا المشهد مع العديد من الأصدقاء.
أتذكر أنني شعرت بالعار نفسه عندما شاهدت قبلةً لأول مرة في مكان عام. كنت أنظر إليهم بطريقة غريبة جدًا، كان شعوري متناقضًا للغاية؛ مزيجٌ من الخوف والعار والتقدير.”


ما تزال الحريات الجنسية والجنسانية في مجتمعاتنا الناطقة بالعربية وفي أغلب دول الجنوب رهينة دساتير وقوانين قديمة، منها التي تمأسست من طرف الاستعمار الفرنسي والبريطاني1 بدعوى الحماية، ومنها التي ضلت حبيسة حقبة تاريخية أكل عليها الدهر وشرب. أما في الثقافات العالمية، فمفهوم الحميمية والقبلة كان وما يزال مدخلا لفهم عادات وتقاليد هذه الشعوب، قد نرى في الخليج مثلا، ذكورا يتبادلون القبل عبر الأنف لإلقاء التحية، وفي المغرب قد يتضاعف عدد القبل حسب معزة الشخص. نقوم أيضا بتقبيل أيادي الكبار في السن في جل دول المنطقة، وقد نقبل الكتف والرقبة وغيرها من التحيات الحارة… ممارسات قد يستغرب منها الأوروبيون و قد تظهر لهم مبالغا فيها.
ولذلك ترددت على مسامعي الكثير من الانتقادات من طرف المهاجرين.ات القادمين.ات من بلداننا بخصوص كمية البرود العام الذي يعاني منه الأوروبيين في التعبير عن مشاعر الحب أو الترحيب. فقد تجد أن الرائج في فرنسا هو تقبيل الخدين قبلة واحدة أو الاكتفاء بالمصافحة بين الذكور، أما التقبيل الرومانسي فيكاد أن يكون رائجا وطبيعيا في المنظر العام.
حسب عالم السوسيولوجيا جان كلود كوفمان، قد تعود إيماءة القبلة أثناء ممارستنا لها إلى تقليد غربي يعود تاريخه إلى الإمبراطورية الرومانية. فيتحدث كوفمان عن ماهية القبلة كتعبير عن الانتماء إلى نفس المجموعة الاجتماعية واختزالها إلى فكرة المساواة الاجتماعية والسياسية بشكل أساسي. فكانت كما اليوم، تتم القبلة بين العروس والعريس في البلدية لإعلان صلة القرابة الجديدة.
و يوضح ألكسندر لاكروا2 أنه تم تعريف القبلة سياسيًا عند الرومان تحت ثلاثة أشكال:
“البازيوم Pasium”و التي تحدث داخل العائلة وقد تكون على الفم و تُفهم على أنها بادرة احترام وتقوي أواصر الاسرة.
“المنظار osculum” و قد تحدث بين أعضاء نفس الجسم السياسي أي بين أعضاء مجلس الشيوخ.
و ال” suavium”: التي تمثل قبلة العشاق.
يشرح جان كلود كوفمان أن “التقبيل كان نادرًا جدًا بين السكان عامة وفي ممارسات الإغواء حتى القرنين التاسع عشر والعشرين. وللتعبير عن العلاقة، كانت ممارسات كالمصافحة و الضرب و البصق على الأفواه رائجة. و منه نفهم أن القبلة الرومنسية أصبحت ديمقراطية بشكل علني في وقت متأخر جدًا، وذلك بفضل التصوير الفوتوغرافي والبطاقات البريدية و السينما. لكي ينتهي الأمر بالقبلة لتصبح مسموحا بها في الأماكن العامة على نطاق واسع منذ السبعينيات.
و للعودة الى بلداننا، فلطالما كنت أتسائل بطرحي لهذا السؤال؛ إن كنا نستطيع التفاعل عبر هذا الكم من الحميمية بين أصحاب الجنس المشابه أو العمر المتقدم، فلماذا تجتاح التابوهات أي لمسة أو قبلة بين حبيبين عكس ما يحصل في اوروبا؟

اجتماعيا، نرجح أن نموذج العلاقة الغيرية كان السبب الأساسي في تفرقة أنواع الحميمية حسب الجندر والسن، لكن علميا، يرجح عالم الحيوانات التطوري ديزموند موريس3 أن فكرة وضع الشفاه على الشفاه تختلف عن بقية التفاعلات الحميمية وقد تطورت من وسيلة لمواساة الأطفال الجياع للتعبير عن الحب والمودة الى أصناف متقدمة من الرسائل العصبية والمواد الكيميائية لاختيار الشريك المناسب جينيا وتوارثيا والتعبير عن الرغبة عند جميع الجنسانيات. غير أن هذا الشرح قد يعتبر سالباً للمعاني المتعددة للقبلة، فحسب العديد من الدراسات السوسيولوجية و الانثروبولوجية؛ الشرح الدارويني الاجتماعي للممارسات التي تعبر عن الرغبة مقصر جدا في الاعتراف بحقيقة أنها لا تتمحور جلها حول التكاثر و الانجاب بالضرورة و انما تتوسع عبر التاريخ و تتجلى في جميع أنواع الممارسات العابرة للجنسانيات و الكائنات الموجودة على الارض.
و من ناحية أخرى، نعتبر أن مفهوم الحميمية و التقبيل لا يتحمل منظورا واحدا حتى بأروبا، فباريس التي هي مقطن المهاجرين.ات في هذا التقرير، تعتبر عاصمة الرومانسية في العالم و يرتادها أغلب السياح لخوض فانتازيا الموعد الرومانسي الباريسي على وقع موسيقى ايديث بياف. لكن لا تزال متلازمة باريس تصيب جل من يرتادها لهذا الهدف. تحصل هذه المتلازمة عندما يشعر المسافر بخيبة أمل من واقع باريس البعيد عن الصور التي تنقلها الأفلام. فيقول لي سام (الاسم المستعار)، وهو لاجئ فلسطيني من مواليد الأردن، أن لحظاته الحميمية كشاب كويريّ بشوارع باريس لم تقل خطورة (من ناحية العنف المجتمعي الموجه ضد مجتمع الميم) عن تلك التي عاشها بشوارع عمان الغربية، التي تُعرف بجانبها المتحرر والتي تقطنها نخبة غالبا ما تكون بورجوازية، عكس نظيرتها الشرقية. ويشدد سام على أن تقاطع الطبقة والثقافة والشكل الخارجي يلعب دورا أساسيا في تكوين هذه التجارب والأحاسيس التي تصاحبها، في الأردن كما في باريس:
“بعمان كنت أُقبّل رفيقي داخل السيارة بين الأزقة الضيّقة ولم أكن أتخذ أي إجراءات أخرى، لكن الأمر أصبح أصعب في باريس، عندما صرت أواعد هنا، صرت أفكر بالمكان والشوارع التي يتجمع فيها المثليين.ات، فعادة ما يكون شريكي خائفا للغاية من التقبيل في الشارع رغم أنه فرنسي ومعتاد على هذا النوع من الحرية.
أنا واعي جدا بأن هذه الشجاعة التي اكتسبتها كانت لها علاقة بالطبقة والمكان الذي ترعرعت فيه، ولها أيضا علاقة بشكل جسمي القوي وطول قامتي، فلا يتجرأ من يعاني من رهاب المثلية على ضربي بهذه السهولة مثلا(…)
عن غير عادة الاستعمار الفرنسي أو البريطاني الذي أسس لأغلب القوانين المجرمة للمثلية في بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الاوسط، فالأردن كالبحرين لا تجرم المثلية بالقانون، وهذا كان عاملا كبيرا في تشجيعي على أول تجربة حميمية دون الخوف من الإعتقال.
كان طبعا لدي خوف كبير من العائلة والأحكام الاجتماعية، لكن بعمان الغربية التي كنت أعيش فيها، كان الوضع أقل تحفظا من عمان الشرقية، فهي منطقة للبورجوازيين بشكل عام. في المنطقة التي ترعرعت فيها كان تقبيل الفتيات وعناقهن أمرا عاديا، لأننا كنا نعتبر أنفسنا من جماعة “الكوول”. عندما كان الأولاد في مدرستي يكتشفون أجسام بعضهم البعض ويتلامسون عن طريق اللعب، لم أكن أجد مكاني بينهم… ففي المرات القليلة التي حاولت أن ألعب معهم؛ شعرت أنني أسبب خللا في تلك المنظومة الذكورية، لأنني لم أكن أشبههم. صحيح، كنت طويلا وقويا لكنني كنت أيضا أتعامل كالفتيات بالنسبة لهم، فعندما كانوا يلمسونني أو يقبلونني كنت أستحي وأضحك وأتبادل بعض النظرات الحميمية مع بعضهم.
هذه اللغة الجسدية كانت تشبه تحدي الذكر” الألفا” لخلق هرمية معينة كتلك التي تخلق في الغابة. لم أكن أفهم كل ذلك حينها، كنت أعيش “ديسفوريا جندرية”، فعلاقاتي في الأردن كانت ” كويريّة” بامتياز، أي أنني لم أكن أتعامل مع الحميمية بنفس الطريقة التي يتعامل بها ذوي الجنسانية الغيرية. كانت لنا لغة خاصة تخرج عن إطار المفاهيم والأدوار الجندرية الرائجة. أما الآن في فرنسا، فأجد أنني أتعامل مع الأشخاص بنفس الطريقة الغيرية المعروفة؛ قد ينزعج صديقي مني إذا لامسته أو تقربت منه بالطريقة التي كنت أعبر بها عن اعجابي بالآخرين في الأردن…”
حدثني سام أيضا عن دور المكان في تكوين منظوره الثقافي والاجتماعي عن جنسانيته وعلاقاته بالأخرين، فرغم الفرق في النظرة الاجتماعية لفعل التقبيل الحميمي بين بلداننا والغرب، إلا أن المنطقة والمجموعة الاجتماعية تكون عادة أساس التجربة الفردية للأشخاص الذين يكوِّنونها. بالنسبة لسام؛ الفعل الكويري الذي استطاع تفكيكه في الأردن لا يشابه في تطبيقه ومفهومه المنطق الغيري المعياري في المجتمع الفرنسي، فأنواع المغازلة والعلاقات المثلية لا تطبق بمجرد وجودها مفاهيما كويرية بالتعريف الحقيقي للمفهوم.
وفعل التقبيل قد يكون محرما اجتماعيا أو قانونيا أيضا في دول الغرب، ففي فرنسا مثلا يحظر عليك قانون صدر عام 1910 تقبيل شريكك في المحطات الفرنسية أو على أرصفة القطار وليس من الطبيعي التقبيل بجميع الأماكن والأحياء، أما اجتماعيا فلم تتوقف يوما الاخبار حول تزايد أنواع العنف الكاره للمثلية، كما تعرض شابين من نفس الجنس لهجوم من قبل حشد عنيف في احدى مظاهرات للوبيات La Manif Pour Tous LMPT Group 4الكارهة للمثلية عقب تقبيلهما لبعضهما أمام أعين الكاميرات.
من ناحية اخرى، لم يكن سام الوحيد الذي عايش مجتمعا مختلفا في البلد الذي أتى منه، فقد حاورت ربيع (الاسم المستعار)، وهو شاب فلسطيني يدرس في الجامعة الامريكية بباريس منذ سنة ٢٠٢٠ وينحدر أيضا من فئة ميسورة تقل تحفظا عن قريناتها داخل المجتمع الفلسطيني برام الله، إلاّ أنه كما سارة، عبّر لي عن تخزينه لمشاعر العار والحشمة المتعارف عليها، ولكنه شدد على أهمية الطبقية في تشكيل مفهومنا عن التجارب الحميمية:
“أتذكر عندما عانقت فتاتا لأول مرة، استوقفني الموقف لمدة معينة، كانت المرة الأولى التي أشعر فيها بجسم دافئ قريب مني، لكنني شعرت بتناقض في المشاعر، كنت أشعر أنني من “جماعة الحرام”. لم يكن لدي خيار آخر، إما أن أعيش حياة مملة أو أن أعايش القلق، ومع وجودي في أوروبا، كنت لا أزال غير متأكد ما إذا كنت أعيش بأمان.

في فلسطين، تعاقدنا أنا وحبيبتي السابقة ألا نلمس بعضنا البعض في الفضاء العام، كنا نُقبّل بعضنا بالسيارة على الجبل ومع ذلك تم الإمساك بنا من طرف رجل شرطة.
في فترة الوباء قررنا السفر الى بيت لحم واستئجار غرف في الفنادق التي كانت قد أصبحت رخيصة بسبب عدم توافد السياح. معظم المحرومين في بلادنا هم من لا يستطيعون تأمين مكان خاص، وأنا أعي أنني كنت محظوظا لأنني كنت أستطيع تأمين سيارة وغرفة في الفندق.
كانت المرة الأولى التي قبّلت فيها شخصا في فرنسا طبيعية جدًا، لم ينظر إلينا أحد، شعرت بالرضا لأنني في هذه المرحلة لم أعد أشعر بالقلق، كنت منفصلاً عن الدين والأحكام الاجتماعية لكنني شعرت بالحزن قليلاً لأنني هدرت سنوات مراهقتي في الشعور بالذنب. تذكرت حينها أول مشهد قبلة شاهدتها في فرنسا وعمري لا يتعدى الستة عشر حينها، كنت في زيارة الى باريس مع أبي وأصدقاءه الذين كانوا يتنمرون ويسخرون من المشهد، لم أستطع تجاوز مشاعر العار والعيب التي رافقتني طويلا بعد هذا الحادث”.
مع بساطة فكرته، يمكن لهذا المقال ألا ينتهي هنا، لأن أبعاده تتجاوز ماهية القبلة و تتطلع لفهم وتحليل المسارات والانتقالات التي يمر بها المهاجرون.ات عبر علاقاتهم.ن مع ذواتهم.ن، رغباتهم.ن والآخرين في المكان الذي يعيشون فيه. في غالب الحالات التي حاورناها خلال هذا البحث؛ كانت الحالة الثقافية والاجتماعية والطبقية تحدد التجارب المتقاطعة والمختلفة بين المهاجرين.ات حسب الجندر و الهوية.
وهذا المقال قد يكون احتفاءا أيضا بالألوان الجديدة التي تظهر في الصورة أدناه، صورة لعائلة وأصدقاء سارة، كبارا وصغارا، هاجروا بذواتهم.ن إى مشهد القبلة الذي لطالما اطفئت الشاشات عند ظهوره.
تقول لي سارة أنها التقطت هذه الصورة وهي تنظر عبرها على كل مراحل الانتقال من صالون بيتهم في سوريا إلى صالون هذا البيت الباريسي في أول دقائق سنة ٢٠٢٣:
“لقد استعدنا حق الحرية في التعبير عن الحب عبر القبلة التي كانت محصورة فقط للمجتمعات الغربية والفئات الأكثر امتيازا ببلداننا، فكيف لتفصيل صغير وطبيعي يمارسه الإنسان منذ الازل أن يتخذ بعداً ثورياً كهذا؟”