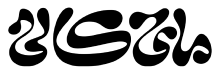بقلم أيمن هدى منعم
الصورة: المثلية ليست ثورة – شارع محمد محمود، القاهرة
يبدو سؤال الهوية وبالنظر لدوامة الانهيار الاجتماعية – السياسية التي يعيشها العالم العربي، والكارثية التي انتهى إليها ربيعه، شديد الإلحاح. فالهوية التي يفترض أن تجسد أعمق مكنونات الحياة الثقافية والاجتماعية للفرد العربي، تعيش اليوم حال الأزمة والتصدع والانهيار. غابت عنها أولاً مفاهيم المساواة، وقبول الآخر، والفكر النقدي، لتغدو نقيضةً للحريةً، ومنحةً تحجب عن كل مخالف، وحاملاً أيضاً لعنفٍ يحكم المجتمع والسلطة، كرسه تماهيها والجماعة الأهلية لعقود.
على الرغم من أن الهوية العربية التي حملت أبعاداً ثقافية أكثر منها قومية، حافظت على كيانها غير مشروطً بالدولة وجوداً أو بقاءً. فهي الجامعٍة فوق الكيانات، والتي تملك سرديةً مقنعةً وغنية، لنشأةٍ خاليةٍ من أكبر قدرٍ من عوامل القلق, تدعمها المرويات الدينية والتاريخية، وإسهام العرب والمسلمين الحضاري، تبدو اليوم مصدر قلقٍ متعارضٍ مع مصالح المنتمين لها، ومنبعاً لأورام الازدواجية القيمية والوجدانية، ولأسئلة الانتماء والولاء، والعلاقة مع الذات ومع الآخر.
عن الجنسانية العربية:
في العالم العربي، ولدى البحث عن ماهية هذه الهوية، أو منظومة المعطيات المادية والنفسية والمعنوية والاجتماعية التي تنطوي على نسق قيمي يفرق بين المتاح والمحرم، يحتل الجنس والدوائر المحيطة به المركز. بحيث تتماهى مع الجنسانية المتضمنةً “للجنس والنوع والهوية الجنسية والميول والرغبات الجسدية والعاطفية، المعبر عنها بجملة الأفكار”، والخيالات، الرغبات، المعتقدات، القيم، الممارسات، والأدوار والعلاقات، والقائمة على أساس الهرمية الاجتماعية، وقاعدة الهيمنة أو التبعية. فالرجال في قمة الهرم، والنساء وقد يكون الصبيان والعبيد “أو من في موقعهم حالياً” في القاعدة، فيما يضاف للمختلفين جنسياً فضاءٌ دون القاعدة، بتطابقٍ تامٍ ربما مع بنى المجتمع، ومواقع أفراده بوصفهم قوةً أو عجزاً.
الجنسانية التي لا يمكن اعتبارها هويةً بحد ذاتها، تحمل إشكاليةً في علاقتها مع الهوية العربية حتى بات من الصعب الفصل بينهما. فهي أهم محدداتها وأبرزها. وهي كنظرة شاملة لتفاصيل الجنس ودواخله، تعطي التفسير الأدق لعلاقات العنف والقوة التي تحكم مجتمعاتنا، على أكثر من صعيد، كذلك الحال في أثر الإسلام فيهما، ودوره في صياغة المفهومين. فالأخير المساهم الأكبر في تشكيل الهوية يقدم للمجتمع نظرته الحالية عن الجنسانية أيضاً، تلك المؤسسة على مجموعة من القوانين تحدد ما إذا كان استعمال الغرائز قد أخذ وجهته الحسنة أم القبيحة، أي يفيد النظام الاجتماعي أو يضر به، باعتباره المحدد للقيمة، لا الغرائز بحد ذاتها، وعليه فالفرد في هذا النظام غير مجبر على التخلص من غرائزه أو التحكم بها مبدئياً، بل إن المطلوب منه ممارستها تبعاً لما تفرضه الشريعة فحسب.
وفي هذا الموضوع يفصل حسن يوسفي أشكوري قائلاً: “تكونت التصورات الفقهية التقليدية للأدوار الجنسانية انطلاقاً من ثلاثة افتراضات أساسية: اعتبار الرجل متفوقاً على المرأة، الحاجة لحماية البنية العائلية الأبوية، ومفهوم العدالة المنسوب إلى أرسطو، فيما حدد النظر لضعف المرأة مقابل الرجل، كمكون جوهري غير قابل للتغيير، تصور الفقهاء المسلمين بأن هدف العدالة هو. المحافظة على كل شيء في مكانه الملائم بما في ذلك اعتبار مقام الرجل المهيمن ومقام المرأة الخاضع. بالتالي، اعتبرت سلطة الرجل التأديبية على المرأة على خلفية ما يراه عصياناً لأوامره مبررةً بحكم القانون بغية المحافظة على النظام الاجتماعي .
في الجنسانية العربية أيضاً تحول جسد الأنثى أو من ينتحل أو يتماهى معه حاملاً ثقافياً، تم إلباسه التصورات الذكورية للثقافة، المحصنة بدعاوى الخصوصية، والمراوحة النظرية غير المنتجة بين الأصالة والمعاصرة، في مجتمعاتٍ سادت فيها إرادة رفض المعرفة وانتجت بوناً واسعاً بين المواقف العامة والممارسات الخاصة، لتتحول وهي الأكثر تحريماً للجنس للأكثر هوساً به بحسب “ميشيل فوكو”. وهو ما يصفه “فتحي بن سلامة”، بانتقال مفهوم الجنس لخارج الخطاب في تاريخ الجنس عند العرب. فلم يعد موضوع خطاب علمي عندهم، بل تحول إلى موضوع مزاح وسخرية في التبادل الكلامي اليومي، فالعرب الذين يمتلكون خطاباً منذ أربعة عشر قرناً عن الجنس، لم يعد لديهم اليوم مفهوم للجنس في اللغة التي يكتبونها ويتكلمون بها بلهجات عدة، واقتصر التعبير عنه بأشكال قولية وسلوكية مرضية “مزاح، نكتة، تحرش، كبت، هذيان .
مما يحيلنا إلى أن النظرية الجنسانية المتداولة اليوم هي وليدة التصور الرسمي للإسلام الذي قُرن دائماً ولا زال يقرن بالسياسة والسلطة، أي أنه لم يتخذ طابعاً ثابتاً حكم تاريخه بل بقي متغيراً ضمن عوامل عدة. لكن هذا المتغير التزم الثبات، مع سقوط بغداد العباسية , والجمود مع أفول الزمن العربي، بحيث عبرت عنه لغةٌ صارمة تقتصر استخدام الجنس لوصف علاقة الذكر بالأنثى فقط، كما جرى تعميم نظرةٍ عن الحياة الجنسية عبر عنها الإمام الغزالي في كتابه “إحياء علوم الدين”، حين اعتبر “أن الحضارة مجهودٌ يهدف إلى احتواء سلطة المرأة الهدامة و الكاسحة، لذلك يجب ضبط النساء لكي لا ينصرف الرجال عن واجباتهم الاجتماعية والديني”.
الجنسانية والربيع العربي
هذا النسق المغلق لعقود، تم اختراقه على مسارين طبقيين إن جاز التعبير , مسارٌ علوي مارسته الفئة المتنفذة برجالها ونساءها، في مجتمعٍ طغى فيه قانون القوة للحد الذي بات معه اختراق العرف أو النسق الأخلاقي مظهراً من مظاهر القوة، وترسيخاً لسطوة المال والفساد والسلطة. أما الثاني فمارسته الطبقات الدنيا اقتصادياً، والتي ليس لها تحمل أكلاف المفاهيم المقبولة اجتماعياً، فباتت تحتال على المنظومة القيمية دون أن تخترقها أو تعترض عليها “الزواج العرفي” في مصر مثلاً، مما يمكن اعتباره تحرراً جنسياً منتزعاً من فئةٍ لم يكن سحقها ضمن القيم الاجتماعية السائدة، كافياً للتمرد عليها.ك
وفي حين تم التعامل عالمياً مع الدوافع والرغبات والميول الجنسية والجسد، حتى أن مجتمعاتٍ أكثر تقدماً أضافت للمتعة التي يؤمنها الجنس والاتصال العاطفي، الحق بالترفيه و ثقافة “اللذة”، وعدتها حقوقاً أساسية، بقي الفرد العربي مكشوفاً للفقر والبطالة، وغياب أي شكلٍ من أشكال الحرية أو المواطنة، فيما تتنافس المؤسستان الدينية والإعلامية على قهره، لينضج حال الثورة، وحدثها لاحقاً. حينها و بنزولها للشارع أوحت الشعوب العربية بأنها ستكسر أولاً حاجز الخوف حيال السلطة الأبوية الكلية الحضور على مختلف الصعد.
فكانت ثورات الربيع العربي بأحد جوانبها تعبيراً عن الطاقة الدافعة للتغيير، وعن قوة الرغبة والحماسة الأساس في توليد الحياة الاجتماعية، التي تعمل تحت الوعي وتحرض أنماط السلوك، طاقة الحياة النفسية “الليبيدو” بحسب فرويد. في مواجهة قيود المجتمع والدولة، وتعبيراً عن أزمة الجسد التي يكفي لبيان عمقها وتجذرها، أن نذكر الرد الرسمي على المتظاهرين , الذي اعتبر الخيام التي نصبت في ميدان التحرير في مصر، أماكن لعلاقاتٍ جنسية كاملة، فيما المتظاهرون في سوريا وتونس “مخنثون، شواذ، إباحيون” ساعون لهدم قيم المجتمع، هذا الوصم اتخذ لاحقاً شكلاً ممنهجاً. فيما بات موضوع الجنس سلاحاً يستخدم في المعركة، فيما المتظاهرون ومن بعدهم لم يكونوا أفضل حالاً، إذ أنه وإرضاءً للجماعة سارع دعاة التغيير للتبرؤ من الثورة, وأعلنوا هدفهم بالتغيير السياسي في المجتمع، لا المساس بقيمه، فيما قدموا لاحقاً، نموذجاً متشدداً فاق الواقع الذي ثاروا عليه بمراحل .
وفيما كان مؤملاً من هذه الثورات أن تكسر الاستثناء العربي الذي حال دون الانخراط في حراكٍ عالمي نحو الحرية والديمقراطية، وأن تقدم فعلاً شجاعاً في مواجهة القيم الاجتماعية التي أنتجت النظام السياسي، ثم عاد وأنتجها، وتعيد تعريف الهوية الوطنية، أضاعت الشرعية الثورية وغيرها من قيم القوة الفرصة. حيث اعتبرت أن من يقاوم أو يقدم التضحيات، محصنٌ من النقد، وشرعيته نابعةٌ من العمل المحض الذي يؤديه، الفكرة التي كرسها السلاح، وأعاد الذكر المحارب هذه المرة على رأس هرمٍ، قاعدته النساء، ودونها المختلفون.