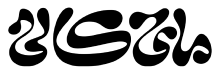بقلم بدر سلاك
ترجمة نوارا علي
الصور: سامية جمال بعدسة لوميس دين ، في نادي ال ‘لاتين كوارتر’ في نيويورك ، 1952
هذا المقال من ملف ‘يا ليل يا عين’ – هيكل العدد هنا
شهد الرقص الشرقي أزمةً عميقة وانتعاشًا خلال العقود القليلة الماضية، يعود الفضل في انتعاشه جزئيًا إلى النجاح التجاري المتزايد، فقد تم الاحتفاء بالرقص الشرقي باعتباره نموذجًا ثقافيًا جنسانيًا “عربيًا أصيلًا”، لكنه يبقى تمثيلًا اختزاليًا أو دلالة مبسطة لفكرة لا تظهر أبدًا، إن شخصية الراقصة الشرقية في السينما المصرية تمامًا مثل المحظيات اللاتي يرتدين الملابس الرقيقة في لوحات روشغروس ولوحات الحريم لشاسيريو رغم تقديمهن مجرد آثار فإنهن يجعلننا نسأل كيف تُتَرجم “الإثارة” إلى العربية ولماذا تم تصويرها فقط في سياق الرقص الشرقي.
كانت السينما المصرية باعتبارها قوة أساسية في افتتان الخيال الاجتماعي في معظم العالم العربي وسيلةً رئيسية في ترسيخ مفاهيم الإثارة والحس الجنسي في الذاكرة الثقافية، ولعبت السينما المصرية المبكرة دورًا كبيرًا في تطبيع شخصية الراقصة الشرقية باعتبارها دالّةً سينمائية مميزة ومجازًا جماليًا وعنصرًا من الاختيار الإبداعي والتوجيه الفني بدلاً من اعتبارها نتاج الفولكلور أو الفن التقليدي.
أدى نجاح أفلام الرقص الأولى لبديعة مصابني بما في ذلك “ملكة المسارح” (فولب، 1936) إلى انتشار أنواع أفلام الرقص التي نبعت من مجموعة متنوعة من التقاليد الموسيقية من الملاهي الليلية إلى الشعبية مما جعل الرقص “سمة لا مفر منها في معظم الأفلام.”1 ساعدت الأفلام مثل ليلى (مزراحي، 1942)، والبؤساء (سليم، 1944)، وشباب امرأة (أبو سيف، 1956) في ترسيخ نموذج الراقصة الشرقية كفاتنة ذات قلب ذهبي وامرأة تشكل موضع الرغبة والاستعباد، وهي شخصية ساحرة تتأرجح بين واقع وآخر كإلهة بين البشر تجوب المجتمعات المحرومة ليلًا.

القصة وراء الضوء القادم من وركي سامية جمال: قام المصور لوميس دين بتوصيل لمبة صغيرة بتنورة سامية ، أسفل سرتها مباشرة وربط الأسلاك المعلقة حول وركها إلى بطاريتين صغيرتين. ثم طلب منها الرقص في غرفة مظلمة ، وفتح العدسة بحيث تم تصوير حركة اللمبة في فيلم الكاميرا ، ومن ثم استخدم ضوء آخر صوبه نحو سامية لالتقاط سامية نفسها. سامية جمال بعدسة لوميس دين ، في نادي ‘لاتين كوارتر’ ، نيويورك ، 1952.
يبيّن صدى هذه الأعمال مدى تأثير السينما في القرن العشرين حيث تمكنت السينما المصرية من أخذ الممارسة الاجتماعية-الثقافية للمجتمع واستخلاصها في الأيقونة المميزة للراقصة الشرقية، ومع ذلك لم يكن دورها ثابتًا دائمًا؛ فتطورت من شخصية العشيقة في الأفلام المبكرة إلى شخصية شبه خيالية يمكنها استحواذ الرغبة وإثارة الإعجاب في عالم قصصي يعنى بالحياة اليومية كما الفولكلور.
على الرغم من وجود الرقص الشرقي كممارسة جماعية احتفالية وفي الحانات والكاباريهات قبل انتشاره في السينما المصرية لم تكن للثقافة العربية سابقًا تقاليد قوية في تصوير الإثارة البصرية، وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت الجاذبية الجنسية للراقصة الشرقية التي ظهرت في الأفلام تشكل بزوغ الإثارة العربية بأكملها محاكية في ذلك شخصية الشقراء اللعوبة والمثيرة في الغرب.
ساهمت السينما العربية في تطبيع صور الرقص الشرقي كمؤشر للتجربة العربية في الجنسانية وجماليتها كما أنجزت ذلك بطرق ثقافية محددة، إحدى الطرق التي صورت بها الأفلام المصرية الكلاسيكية من الخمسينيات إلى السبعينيات من القرن الماضي الإثارة الجنسية العربية كانت بأرواب واسعة الشكل وفساتين صيفية وجلابيات فضفاضة مما وضح حساسية تجاه الشكل والقوام وراء القماش الفضفاض ويشمل ذلك حتى الراقصات الشرقيات اللواتي يرتدين قطعة قماش صغيرة أو وشاحًا حول خصرهن وهي علامة متكررة في معظم الثقافات “الشرقية”. على الرغم من أن هذا النوع من الصور المثيرة لم يدم طويلاً مقابل “الجمالية الأكثر حداثة” إلا أنه لا يزال يحتل مكانًا مهمًا في الذاكرة الثقافية العربية ويسمح لنا برؤية الجانب المثير في الملابس اليومية التي نراها في المنازل وفي شوارع المدن العربية.
ليس من المستغرب أن يكون هناك عنصر لا زمني مرتبط بهذا التمثيل والذي يتم الحفاظ عليه جزئيًا من خلال تقاليد أداء الرقص الشرقي، ويتعلق الأمر بتمثيل الجمالية (البلدية) الأصيلة التقليدية الموجودة على النقيض من تلك المعاصرة.

سامية جمال ترقص أمام زوجها في ذلك الوقت، شيبارد كينج الثالث. تصوير لوميس دين . سامية جمال بعدسة لوميس دين ، في نادي ‘لاتين كوارتر’ ، نيويورك ، 1952.
أصبح الرقص الشرقي الآن شائعًا في الأفلام التجارية العربية ومقاطع الفيديو الموسيقية ولكنه مجرد خيار جمالي يذكرنا بالماضي في هذه الإعادات المعاصرة، فمنذ التحول في سبعينيات القرن الماضي نحو أيقونة الجنس الحديثة التي ترتدي ملابس المكتب والأحذية الجلدية أصبحت الراقصة الشرقية بمثابة القطعة الثابتة، لقد منع هذا التحول استكشاف ممارسة الرقص الشرقي وجردها من أهميتها في عملية تسارعت خطاها من خلال التسليع.
إضافةً إلى ذلك لا تزال شخصية الراقصة الشرقية منمطة ومستولاة في الأفلام والصور الغربية وغالبًا ما يتم تصويرها برومانسية تحت نظرة المستشرقين. كتب أنتوني شاي وباربرا سيلرز-يونغ أن “الشيوخ والأئمة والحجاب والجواري المرتديات ملابس ضيقة […] كلها صور مألوفة في الأفلام” وأن “المصطلحات مثل ‘الجاذبية’ و’الغموض’ تكثر في الإعلانات والمقالات في منشورات الرقص الشرقي”2. إن صور الرقص الشرقي مثل الأشكال الثقافية الأخرى المُسلَّعة من الكناوة والمنسوجات التقليدية إلى الهندسة المعمارية والفسيفساء يتم إزالتها من سياقها وتجميدها زمنيًا، وتم التعامل مع الرقص الشرقي على أنه شيء جديد أو”من عالم آخر” حيث تم توظيفه في مجموعة متنوعة من المساحات خارج الشاشة في الغرب في الستينيات بما في ذلك الكاباريهات والنوادي الليلية والحفلات والمطاعم، وغالبًا ما يؤول ممارسو الرقص الشرقي إلى استخدام أسماء عربية (أو شرقية… قد تكون تركية أو فارسية أو هندية) بنفس النمط.
أمسى “الرقص الشرقي” مصطلحًا يشمل مجموعة متنوعة من الأساليب، وهذا بالإضافة إلى الصور المختزلة الناتجة التي تجسد الثنائية بين “الجمالية الشرقية / العربية الخام” والجمالية “المعاصرة الحديثة” (المتأثرة ضمنيًا بالثقافات الغربية) يظهران كيف يمكن للإعلام والتسويق أن يغيّرا الثقافة والتاريخ الثقافي بشكل جذري، واشتدت هذه الظاهرة فقط عندما اكتسب الرقص الشرقي مزيدًا من الاهتمام على مستوى عالمي وأصبح جزءًا من مساحة افتراضية مشتركة يتم فيها تفكيك الأشكال الثقافية وتجريدها من خصوصياتها الجمالية، إن قطع العلاقة بين الممارسة الثقافية والإحساس المحلي يجعل الرقص الشرقي مختزلًا إلى شيء يمكن تصويره بسهولة وتعميمه وتبادله في المجال العام.
يسمي ج.م. هيرنانديز مارتي هذا إزالة الطابع الإقليمي، وهي عملية “تتحدث عن فقدان العلاقة ‘الطبيعية’ بين الثقافة والأقاليم الاجتماعية والجغرافية” و”تصف تحولًا عميقًا في الصلة بين تجاربنا الثقافية اليومية وتكويننا كأناس محليين”، وبالتالي فإن هذه العملية “تصنع فوائد ولكنها تنتج أشياء واضحة كالشعور بالضعف 3 الوجودي أو انعدام الجذور الثقافية”.
بقايا الرقص الشرقي التي نراها في وسائل الإعلام اليوم هي مجرد عودة للظهور وهذا هو موت الشكل الثقافي، لم يتسبب فقدان الشعور بالوحدة الجغرافية والاجتماعية في موته فقط بل كذلك فعل المفهوم الوحيد للرقص الشرقي الذي نتج عن سلسلة من التسابق للحصول على السلطة الذي لا يزال تطاردنا في الوقت الحاضر.
لقد تسبب الرقص الشرقي خلال معظم التاريخ الحديث في إزعاج السلطات التي حاولت تقنينها وتحويلها إلى “مهنة مشروعة” أو إبعادها تمامًا، كان الرقص الشرقي شوكةً في عين المجتمع المثالي الخالي من الرذيلة وأثار الفوضى في هذه الفكرة لمعظم المجتمعات الناطقة بالعربية.
محاولات السلطات لتقييد الرقص الشرقي هي جزء من مشروع أوسع يهدف لفرض المعايير الاجتماعية والثقافية لإنشاء مجتمع من الرجال والنساء الفاضلين، ويعتمد هذا المشروع على تقسيم أساسي بين “المستوى العادي” الذي يمكننا الاعتراف به على المستوى الثقافي و”المستوى السفلي” الذي يجب إبعاده هو ملعب الجوانب الوسخة من التجربة الحياتية، لكن الرقص الشرقي معلق بين هذين المستويين حيث يمثل كل من الفولكلور والتقاليد وعالم سفلي من الانغماس والانحلال في آن واحد.
لا يبدو أن هذا الجدل المستمر حول أهمية الرقص الشرقي أو التكافؤ الأخلاقي يؤثر على الممارسة نفسها، وعوضاً عن ذلك فإن إزالة السياق والتسليع هما اللذان حولا الرقص الشرقي من شيء جديد ذا قيمة مؤثرة إلى واحدة من العديد من العلامات المرئية الغريبة، إن عملية إزالة السياق هذه عملية مهمة: فقد منح انخراطها في السينما للرقص مكانًا في خطاب ثقافي أوسع، وإن اندماجها في السوق الدولية للسلع والأفكار اختصرها في مجرد صفات جمالية، ما تبقى هو ترسبات “شبحية” تعنى باستمرار عنصر من الماضي أعيد تقديمه في شكل جديد.

تصوير لوميس دين ، في ذا لاتين كوارتر كلوب ، نيويورك ، 1952.
هناك أزمة متأصلة في إحياء الرقص الشرقي والاحتفال بالإيروتيكا العربية، إذا كان الإحياء يعني إعادة اكتشاف الأشكال والممارسات الثقافية “الميتة” وإعادة تخيلها وتقديرها فهذا يمثل بالضرورة النوستالجيا، إن إحياء عنصر أو شكل ثقافي ليس مجرد حنين إلى الماضي ولكنه غالبًا ما يصف النجاح التجاري والشعبية المتزايدة حول العالم والاختلافات والأساليب الهجينة. هل الذي يكمن في الجانب الآخر من هذا هو انهيار الشكل الثقافي وإضفاء الطابع الإقليمي على الممارسة الثقافية وموازنة الثقافات؟ هل تستطيع الإيروتيكا العربية أن تتجاوز التصورات المبسطة للرقص الشرقي والنظرة الاستشراقية؟
تهدف حركة إحياء أوسع في المشهد الفني العربي المستقل إلى القيام بذلك بالضبط: فهي تحيي الماضي وتستحضر التقدير له وتتكيف مع العناصر لإظهار علاقته بالحاضر4، ورغم استقبال هذه المحاولات بشكل إيجابي من قبل المعارض الفنية والمنسقين إلا أن تصوير الحسية والإثارة ما زال مبهمًا لأسباب أخلاقية و/أو دينية وفي الغالب بسبب المنعطف المفاهيمي الذي اتخذته الإيروتيكا في العقود الماضية. ومع ذلك فإن هذه الأداءات (وحتى فكرة الإيروتيكا العربية) لا تزال تفوح منها رائحة أخطاء تاريخية.
ما هو دور الإيروتيكية العربية والتواريخ الثقافية في حركة إعادة الإحياء هذه؟ هل يمكن أن يكون دورها في إعادة اكتشافه بالإضافة إلى الشكل الرد المناسب لهذه الأخطاء؟
إن وظيفة إحياء الممارسات الثقافية بشكل جوهري هي حل هذه الأشكال الثقافية الميتة، إذا كانت هذه الحركة تختصر فهمنا للرقص الشرقي والإيروتيكا العربية في جوانبها الممتعة فقط فسيكون ذلك بعيدًا تمامًا عن عملية الإحياء المثالية، يصبح هذا مثيرًا للاهتمام بالنسبة للرقص الشرقي نظرًا إلى أن مظهره أو سبب كونه مثيرًا للجدل -حتى لو كان على مستوى ضمني- لا يزال يمثل مشكلة، سيعمل هذا الاختزال هنا كوسيلة لتفكيك “الشكل الثقافي الميت” ومع ذلك إذا أعادت عملية إعادة الاكتشاف هذه تعقيد الرقص الشرقي وتاريخه للعيان مرة أخرى، فقد تكون هذه هي الحدود النهائية لمشاهد الفن العربي المعاصر.
كم من التاريخ الثقافي لهذه الأشكال يمكن تعريته قبل أن ينفصل التمثيل عن التجربة الفعلية ويصبح مجرد ارتباط بالماضي؟ قد تكون إعادة اكتشاف الإيروتيكا العربية الحدود النهائية لهذه الحركة أو شيئًا قصير العمر مثل التمثيل الذي تحاول إحيائه.
- Galal El-Chakawi, “History of the U A R Cinema, 1869-1962”, in The Cinema of Arab Countries , ed. Georges Sadoul. (Beirut: Interlab Center of Cinema and Television, 1966), pages 69-97.
- Anthony Shay and Barbara Sellers-Young. “Belly Dance: Orientalism—Exoticism—Self-Exoticism.” Dance Research Journal 35, no. 1 (2003): 13–37.
- Gil-Manuel Hernàndez i Martí. “The deterritorialization of cultural heritage in a globalized modernity.” notes & comments, no. 1 (2006): 91-107. Quotes from pages 93-94.
- See: Mona Trad Dabaji, Haifa (2008), Life is Beautiful (2006), and Nu au Sheh VII (2013); Laila Essaydi, Harem Revisited (2012); Yousef Nabil, Fifi with shisha, (2000) and I saved my Belly Dancer (2015)